مع انها بلغت المئة فانّ وجهها الذي تحت الاضواء ابداً، لا يزال يُشرق بماءِ النضارة والجمال. لم تأكله تجاعيد، ولادبَّ، في قسماته، يباسووليدها وغريمها التلفزيون الذي لم يألُ، منذ كان، جهداً لدفعها إلى التقاعد، وإفقادها المكانة التي لها، والذي يعمد، الآن، إلى تكبير شاشاته تشبّهاً بها، ومحاكاةً لفتنتها، لم يسلُبْ بهرجها وجاذبيّتها. وقد أعطى، قبل هذا العام، إلى ألف مليون مشاهد، في مئة بلدٍ، ما حرق أسعار مساحاته الإعلانيّة على نحوٍ وصل الأّمر مع شبكة آي.بي.سي إلى حدّ بيع ثلاثين ثانية بما يقارب النصف مليون جنيه إسرلينيّ
و”للبيت الثقافي”، بالتأكيد، حقّ الشفعة في هذه الوقفة الإستعاديّة لتاريخ السينما في زغرتا – اهدن بوصفه آخر هيئةِ محليّةِ، تعير السينما إهتماماً من طريق الحفلات الدوريّة ل”نادي السينما” في صالة “الكونكورد”، هذا إذا لم نقل بانه الوحيد إيلاءً لمثل هذا الإنتباه للسينما، منذ سنواتٍ، في وقتٍ هبطت فيه نسبة الإقبال إلى مستوياتها الدنيا المنذرة بإقفال ما بقي، فيما السينما، في العاصمة، وقريباً منها، في حال فورانٍ وإنتعاش
لذلك لم نستغربْ عندما وجَدَت حلقاتنا الإذاعيّة الاربع (عبر إذاعة اهدن) المثبتة في وكالة ابناء الشرق – الشمال (الاُعداد 110-113 ما بين شباط وايار 1992) حول هذا الشأن، صدىً طيباً في أوساطه، كونها حركت منه وتر إهتمام. كما إنّنا لم نستغربْ، من ناحية أخرى، صعوبة تجميع وحصيلة معلوماتية تمكّننا من رصد مسيرة السينما، مذ كان لها، عندنا، وجود وتاريخ. فمثل هذا العمل دفع الناقد والمؤرّخ السينمائيّ العالمي جورج سادول إلى إطلاق الصفة الإفتراضية على جهده التأريخّي لتلاشي المحفوظات العائدة إلى البدايات السينمائيّة العالميّة. هذا في العواصم والبلدان التي تزخز بالصحف والدوريّات المسجّلة للوقائع، يوماً بيوم، فما بالك بالأنحاء التي كانت تفتقر إلى الأعمدة الصحفيّة المغطّية لفجوات الزمن؟ لذلك لم يتمالك سادول تعبيراً عن ذهوله حيال الضآلة الاُرشيفيّة لفنّ وُلدِ، بالمقارنة مع الفنون الأخرى الموغلة في القدم كالموسيقى، والرسم، والمسرح، تحت أعيننا
ولذلك، تالياً، شبهّ تصرّف الباحثِ، في هذا المجال، بتصرّف عالمٍ من علماء مطمورات الارض الذي يعيدُ تركيب حيوان معيّنٍ مبتدئاً ببعضِ العظام، متمنّياً الاّ تأتي الاِكتشافات القادمة فتهدم إفتراضاته
محكوم بمثل هذا الشعور بالتعاطي مع المطمورات إذن، إستعراضنُا لتاريخ السينما في زغرتا – اهدن، واو كانت دائرة بحثنا مجهريّة بالقياس إلى وسع الدائرة التي خصهّا سادول بعنايته الفائقة، وتوضيحاته المدهشة. سوى انّه لا يتورّع عن توفير مادة للمتقصيّن والمستطلعين، ونقاط إرتكاز لمن يساورهم التوسّع أكثر في ما إكتفينا منه بهذا القدر
الدخول- الحدث
اذا حاولنا إسجلاءَ غوامض البدايات، في غباشةِ الفجر السينمائيّ، وفجر القرن العشرين، في آنِ، لبَانً لنا الآتي: في 1901، أيّ في العام السادس لظهور السينما، كانت بالتأكيد، تصطافُ، مع من لانعرف، في إهدن. وقد أماط اللثام عن هذا الدخول- الحدث الأديب الطرابلسّي نسيم خلاط في كتابه “سياحة في غربيّ أوروبا” الوارد عنه في “سراج الحبر” للأستاذ أنطوان القوّال، قائمقام بشري (طبعته “المقتطف” في مصر، عام 1901) حيث جاء عن السينما ما حرفه”… ذهبت إلى ملعب الهامبرا (في لندن) فدخلته وقد صَعِب علىّ الوصول إلى مكاني لشدّة الزِخَام فوجدته عظيماً في كلّ شيء في الزخرف والإتّساع، وفي براعة اللاعبين ولياقة الراقصين، ورهجةِ الملابس، وفي مناظر السينوماتوغراف الفنّ الحديث النشأة فرأيتُ بها مواقع حرب الترنسفال. مناظر كنت أقول إنّي دُهشت لها لولا أنني بعد وصولي إلى مصيفي، في إهدن، وجدتها سبقتني اليه…”
على كوننا إستقينا، في ما تقدّم، من مرجع كتابيّ، فان هذا الإنتقال السريع للفنّ السابع، الى اهدن، ربما كان مثارَ دهشةٍ، لكن هذه الدهشة تزولُ بمجرد الأخدِ في الإعتبار، انّ مصر كانت عرفت السينما، بعد نحو شهرٍ من ظهورها. ففيما العرض السينمائي العالميّ الأوّل، في الصالون الهنديّ، في المقهى الكبير، في شارع كابوسين، في باريس، عام 1895 (في كانون الاول)، فالعرض السينمائي الأوّل في مصر، في مقهى زواني، في الإسكندريّة، في أوائل كانون الثاني 1896. وبسبب نجاحِ العرض الإسكندراني الأوّل الذي تلاه آخر قاهريّ، في العام نفسه، في حديقة الأزبكية، إستورد بعض المتموّلين والتجّار الأجانب أفلاماً اخرى، وانشأوا صالات سينمائيّة.
فمن مصر إلى إهدن خظُّ انتقالٍ ممكن. فالإحتمال أن يكون أحد المصطافين الطرابلسيّي الأصل، من نزلاء مصر، أو من المصريّي التابعية، وهم لم يقلّوا عن الطرابلسيين او الحلبييّن تعلّقاً بصيف اهدن، حمل مع حقائبه، إكتشاف “الأخوة لوميير”، في أوّل عهده، فنَعمَ مَنْ نَعِمَ بالعروض الاولى، وفَرك عينيه إنبهاراً
ولأنّ كتاب خلاط بَخُل علينا بأكثر يصعبُ معرفة المزيد حول من واين، وهل كان وصولها سنة صدور الكتاب، أو قبلها بقليل؟! وهل في احد البيوت الصغيرة، ذات الحجرة، او الثلاث التي راح الاهالي يشيّدونها، وبخاصة على كتف الساقية، بين كروم العنب، بقصد تأجيرها للعائلات الطرابلسية التي كانت تتدفّق إليها، صيفاً، على ما يخبرنا المؤرّخ نسيم نوفل في مؤلّفه “كتاب بطل لبنان” المطبوع في الاسكندرية، عام 1894؟ وهل في نزلٍ، ام في مقهى؟ في أيّ حال، لانميلُ إلى التسليم بأن يكون الأمر تجاوز نطاقَ شريحوٍ إجتماعيةٍ محدّدة، لذلك وصفناه بالإنتقال كي لا نَسِمُه بسِمِة الإنتشار السابق لأوانه. أمّا الشريط المعروض (وربما الاشرطة؟) فمضمون الإندراج في خانة الأفلام التسجيليّة، لأنّ السينما عاشت ما بين 1895 و1902 على التسجيل المباشر للواقع
مرحلة غامضة
منذ ذلك التاريخ، حتى صدور جريدة “إهدن” بطرس افندي يميّن، عام 1913، وليس هناك، بين يدينا، ما يزيدّنا علماً ببقاء البلدتين التوأم: زغرتا-إهدن، في الاقل صيفاً، على صلة بهذا الفّن. كما إنّ تقليب المتوافر من أعداد جريدة “إهدن” يخلو كليّاً من أيّ إشارةٍ مفيدة، بهذا الخصوص.
في الحرب العالميّة الاولى: حصارٌ، عزلة عن العالم، جوعٌ وتيفوس وسيناريو دراماتيكيّ لكاتبٍ واحد: جمال باشا. لذا لا بدّ أن تكون السينما قد أضحت ترفاً خالصاً لشعبٍ هلك ثلثُه في غضون سنواتٍ اربع.
بداية إجتماعيّة – فنيّة
بحلول الإنتداب إنفتحت صفحة جديدة راحت معها السينما تتسلّل، أكثر فأكثر إلى حياة كلً يوم، بدءاً من اللوكندات والمقاهي. ولم يمضِ شهرٌ ونيّف، على صدور “صدى الشمال”، ثاني صحف البلدة، وأطولها عمراً، حتى نقلت الى القرّاء في عددها التاسع (الخميس 27 آب 1925) “خبر إحياء ليلة سينما يتخلّلها غناءٌ عربيّ في لوكندة إهدن الكبرى لمستثمريها سعيد الخوري وسليم سمعان معوض، مساء السنت في 29 آب 1925. والدعوة من ” الجمعية الخيرية الإهدنية” التي رئسها المحامي فريد أنطون، صاحب ال”صدى”. الخبر لم يُرفق بمعلوماتٍ عن الفيلم، عنواناًومدّةَ، ولا حتى عمّن للغناء ليلئذ، إنمّا إنبراء الفيلم، عنواناً ومدّةَ، ولا حتى عمّن للغناء ليلئذ، إنمّا إنبراءُ الشيخ سعيد مرعشلي للغناء في معاونة جوقٍ من الموسيقيّين، أسبوعاًقبل ذلك (وفقاً للعدد الثامن 20 آب 1925) يميلُ بنا الى ترجيح إعتلائه منبر الغناء وتقاسمه، وما رُمي على الشاشة، إنتباه الساهرين والساهرات.
مشافهاتنا حول تلك الآونة، تُبرز لنا جوّاد الجعيتاني (1912-1981)، وجميل الجعيتاني (1901-1985)، الأوّل كمشغّل (أوبيراتور) لماكينة الكبرى، وهو بعد فتىً، والثاني كمشغّل لماكينة اخرى تُثبّت، في وقت متقاربٍ، في مقهى “الكازينو” لصاحبه الشيخ رشيد معوض، في الميدان. كلاهما عاد فنقل عدوى الإهتمام إلى أسرتيهما: جوّاد إلى إبنه سركيس، والثاني، أي جميل إلى ولده رشيد. والغالب على الظنّ أخذهما للكارِ عن الفرنسيّين الذين أقاموا سينما خاصة بجنود “جيش الشرق”، في عنبر خاص، في بقعةٍ من محلّة “العبي” عُرفت، على ألسنة العامة، ب”السينما”. وقد حلّ محلها، منذ سنوات قليلة، مقهى ال “جيبسي”
من هذه الزاوية، يمكن الحديث عن مجموعة عوامل تضافرت وأعطت السينما قوّة دفع لمدّ نطاق تأثيرها وجاذبيّتها. فمجيء الفرنسيّين، وتغيّر أحوال البلاد بعد الحرب الاولى، وتطوّر الفنّ السينمائيّ، أدت، مجتمعةً، إلى زيادةِ نسبةِ
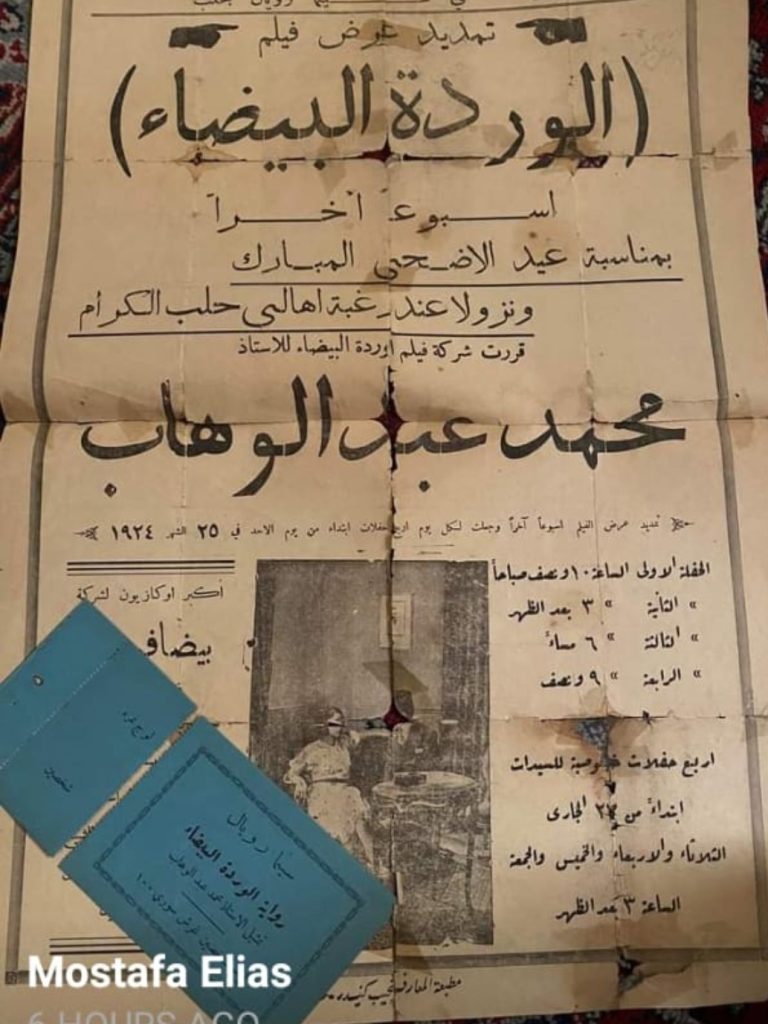
الاقبال، في ذلك الحين، على الشاشة الكبيرة إهدن في السينما المصريّة
عامان بعد ذلك، أي في 1927، زار طلعت باشا حرب إهدن، فأدرجت ال”صدى” خبر زيارته وإلتقاطه، سينمائياً، لمناظلا اهدن برفقة ميشال شلهوب دون أن تُشبع فضولنا لمعرفة المزيد عن هذا الباشا. الاّ اننا من تقليبنا للمراجع علمنا أنّ الرجل لم يكن حاكم بنك مصر فحسب، بل كان إسماً عَلَماً في تاريخ السينما المصرية لتأسيسه “شركة مصر للمسرح والسينما”، عام 1925، أي قبل زيارته، وتأسيسه المشروع السينمائيّ الضخم :”استديو مصر” في الجيزة، بعدما، أي في 1934. ويعود إلى هذا الاستوديو، في ما يعود إليه من أفضال، تطوير الفيلم الكوميديّ المصريّ، وتجربة الفيلم البطوليّ الوطنيّ، وإيفاد طلائع الساعين لدراسة فنّ الاخراج، في الخارج، والتعاقدِ مع من كان سبقهم.
وأيّاً كان الامر، من المستبعد أن يكون طلعت باشا إرتاد ظلال إهدن الظليلة وأنعم النظر في جمالاتها، لوحده، بل ربمّا كان صحبه طاقم فنيّ على قدر ما كانت تحوجه تقنيّة تلك الأيّام، وهو في الموقع المعلوم. ومن المحقّق انه لم يكتفِ، حين أقفل عائداً، بطعم الكبّة مشوية تحت أضراسه، بل أخذ معه “المطلّ والشربين والنبع والدواليب والحرج” وسحر الحجر والقرميد قبل هجمة الباطون المظفّرة.
فيلم إزاحة الستار
مرةً اخرى، عبرت إهدن إلى الشاشة وهي تدبك وترقص وتطلق البارود والحوربات في عنان السماء، في واحد من أيّامها التاريخيّة، عنينا يوم إزاحة الستار عن تمثال يوسف بك كرم، يوم الاحد في 18 ايلول 1932، حين إتّخذ المغترب الحصرونيّ يوسف متّى مكاناً له، ولعدسته، بين الجموع المتدافعة، وإنصرف إلى ألتقاط وقائع الفرحة الشعبيّة العارمة المتفجّرة بحضور ممثّلي الإنتداب وأركان البلاد، ديناً. وفي ظنّنا انه لم يُفوّت على نفسه فرصة تسجيل قفزة غصوب فرنجيّة إلى دكّة التمثال لإزاحة الستارة العالقة، وإلى ظهر الحصان لإفراغ ما في مسدسّه في الجوّ العابق بدخان البارود.
فيلم متّى الذي كان موضوع مقالٍ لنا في “النهار” في 12 ايلول 1984، عُرض كاملاً في 25 آذار 1933، ولمدة اربعة أيّام متتالية، على شاشة سينما حلوان بالاس، في طرابلس، مع فيلم “دار الحرم” (راجع “صدى الشمال”- عدد 658- السبت 25 آذار 1933) ومجزوءاً، في سينما “البايو” في الستّينيّات، لانّ نسخة منه ظلّت محفوظة في زغرتا، حتى إندلاع أحداص ال 1958 حين سُرقت من مكان حفظها، وتناتشها صبيةٌ تدافعوا إلى المكان. ولم تُعرض منه، بعدئذ، سوى الشقفة اليسيرة التي غنِمها شخص أسرّ لنا بالمعلومات، وعاد فأرسلها بعد الضجّة التي أثارها العرض، إلى شقيقه في أوستراليا حيث لا علم لنا هل مُصانةً، حتى الساعة، أم أضحت أثراً في حافظة مشاهديها بعد عين؟ وعبثاً إنتظرنا أن يحمل بريد هذا الشخص إلينا نسخةً من البقيّة الثمينة، لكننا نتلقّ سوى الوعود تتلوها وعود. ويوم فقدنا الأمل ككتبنا “النهار” بقصد الإستنجاد بكلّ من يعتبر نفسه معنياً بفيلم لا تفصله عن “مغامرات الياس المبروك”، أوّل لبنانيّ، في 1929، سوى شقّة زمنيّة وجيزة.
نحو الحفلات المنتظمة
حتى ذلك الحين، لا حفلات منتظمة في دور عرض ثابتة، والسينما لم تجاوز طورها الصامت صمت لاعبي الورق الذين لم يكن يفكُّ عقال ألسنتهم ألاّ التعليقات المتراوحة بين الطرفة والسماجة على الشريط الأخرس. وسيمرّ وقت قبل أن يشرع الفيلم الناطق في فرض الصمتِ والهدوء على المشاهدين. وأفلام المقاهي كانت من القصر بحيث لا تتيح لبعض الحاضرين الإستسلام للنعاس اللذين المطبق على الأجفان قيل أن تعيدهم إلى اليقظة ضجّة تستثيرها الوقائع، بعفويّة، من المتابعين، أو صخب يفتعله جارٌ متشيطن. وهو ما كان يحصل في زماننا، حين كنا نلاحظ أنّ بعض الروّاد ما ان تغمر العتمة الصالة ويبدأ العرض حتى ينفتح المجال، واسعاً أمامهم، للغطّ في نوم يتبعه شخير يتقاطع، برتابة مزعجة، في أسماعنا، والموسيقى التصويريّة المتعالية في القاعة. فكأن الصالات كانت بالنسبة إليهم مكاناً أثيراً للنوم بعيداً عن مشاكل البيت، ومطالب النساء و”نقارهن”، وسائر الهموم اليوميّة. أس أنهم كانوا كمن يدفع ثمن غفوته مع أنّ النوم، على حدّ علمنا، مجانيّ.
وتصاعد معدّل الإقبال هو الذي سيّملي على بطرس سليم المكاري، صاحب مقهى في محلّة الساحة، في زغرتا، أخلت، في ما بعد المكان ل”سينما مرسال”، تقديم عروضٍ ثابتة شتوية، بمعدّل مرتين، أسبوعيّاً، في مقهاه. ولا يعيب السينما وتاريخها المحليّ انها ظلّت ردحاً من الزمن ملازمة للمقهى، ولقرقرة الأراكيل، ول”نارة يا بشارة”، و”بنج وسي”، فهكذا كان الشأن في العالم جميعه. اذ كيف يكون ثمة صالات حين لا سينما؟ من الطبيعي، والحالة هذه أن يستضيف المقهى الأسبق إلى الولادة، إجتماعيّاً وترفيهياً، العروض الأولى، في إطاره المعهود، غربيّاً كان، أم شرقيّاً. ولو حاولنا إستطلاع وضع الدور السينمائيّة في طرابلس، آنذاك، لتبيّن لنا انها، هي الأخرى، لم تشذْ عن القاعدة، وما لم يًولد من قديمها، في المقهى، كان ينتقل إليه، صيفاً، فتقدّم العروض في الهواء الطلق. فسينما “الأمبيرالصيفيّ” كان على سطيحة مقهى ماريات باشا، “والسينما الجديد” لصاحبها ميشال التويني كانت تنتقل الى حديقة كازينو التويني الصيفيّة، وسينما “حلوان بالاس” التي أبدلت إسمها بآخر: سينما الروكسي إختارت “حديقة المتني” (شارع يزبك الآن) مكاناً لعرض أشرطتها في الهواء الطلق تخفيفاً على غواة الشينما من وطأة الحرّ الشديد على لغة جريدة “الدفاع” لصاحبها الشيخ الراحل فريد بولس (عدد 249- الخميس في 13 حزيران 1935). وما دمنا أتينا على ذكر “الدفاع” فهذه الجريدة هي التي زفّت إلى المهتميّن بشرى “حفلات السينما الدوّار الناطق في زغرتا” بدءاً من 15 تشرين الثاني 1933 (راجع العدد 152 الخميس في 16 تشرين الثاني 1933). أمّا أوّل عروض مقهى بطرس المكاري “الجديد” فكان “أنشودة الفؤاد”، وهو أوّل فيلم مصريّ ناطق جمع عدداً من النجوم: ندرة وهي مغنّية ذائعة الصيت، زكريّا أحمد، المطرب والملحّن المعروف، جورج أبيض، الكوميدي المشهور الذي إنطلق من المسرح، أساساً، دولة أبيض وعبد الرحمن رشدي. أخرج “انشودة الفؤاد” ماريو فولبي وكتب أغانيه الكاتب الشهير محمود عبّاس العقّاد.
وعليه، يكون 15 تشرين الثاني 1933، تاريخ بداية الحفلات السينمائيّة المنتظمة في زغرتا، وتاريخ عرض أوّل فيلم ناطق فيها، في آن.
الصالة الاولى: سينما مرسال
مع تنامي الاهتمام وجد كل من فؤاد الداية (1901-1966)، وبطرس أنطون يمين أن ظروف إستثمار دار عرض في زغرتا باتت ناضجة فاتّجه تفكيرهما، في نفس الوقت، الى رخصة من الحكومة اللبنانية كانت الواسطة السياسيّة الى جانب أوّلهما فإستحصل عليها. وكانت البداية، مرّة اخرى، من إهدن، في وقت كان تقاطر المصطافين العرب إليها (من مصر، وسوريا، والعراق، وفلسطين) قد بلغ أوجه. فإختار الدايه بناية شلهوب، في ميدان اهدن، مكاناً لصالته الصيفيّة، وأطلق عليها إسم إبنه البكر: “مرسال”. وهنا الخبر كما نشرته جريدة “الدفاع” تحت عنوان “السينما في اهدن” في عددها 331 الصادر يوم الثلاثاء في 3 آب 1937:
“إفتتح الاديب السيد فؤاد الداية داراً جميلة للسينما في عروس مصايف الشمال اهدن. وبدأ يعرض أجمل الأشرطة والأفلام، في هذه الدار الجديدة المؤثّثة بأفخم الأثاث، والمرتّبة ترتيباً حديثاً جميلاً. ولا شكّ ان الشماليّين سيُقبلون على دار السينما الجديدة في مصيف الشمال. والدار تقع على ساحة ميدان اهدن، في بناية شلهوب”.
والملاحظ أنّ “صدى الشمال” التي لم تنشر البنأ الاّ في عددها الصادر في 8 آب أعاضت عن التأخير بتحديدها إسم السينما: “مرسال”، وإسم مالك البناية، أي المرحوم أمادو شلهوب.
الوسيلة الاعلانيّة الأولى التي إعتمدها فؤاد الدايه تنبهاً للأهلين إلى ما كانت تعرضه من أفلام كانت تجري على النحو التالي: تعليق “أفيش” الفيلم على لوح خشبيّ يحمله أحدهم ويطوف به، في شوارع البلدة، مصحوباً بولد، أو اكثر، لرنّ الجرس، أسترعاءً للإنتباه. هذا الموكب الإعلانيّ قاده، مدّةً، المرحوم “شهيد العاقوري”، بائع لليموناضة الشهير في البلدة، في رفقة صبية يتطوعون مدفوعين بحماسة إنوعادهم بالدخول المجانيّ إلى السينما. لأنّ ثمن تذكرة السينما. في أوّل عهدها، كان يتطلّب ما يفوق مصروف جيب عامة أولاد البلدة، خصوصاً المُكْثرين من التردّد على صالتها الاولى، فقد كان الصغار يتحيّنون فرصاً عديدة للظفر بنعمة الإرتماء لساعة، أو ساعتين، على مقعد، أما الشاشة الفضّيّة، فيغتنمون، في ما يغتنمون، حالات قلة الإقبال على الدار سانحة. أمّا صاحبها فكان يخفّض، وفقاً لنسبة الحضور، أسعار الدخول لمن تجمهر في خارج. إلى ذلك كان الأولاد يترقّبون البرهة التي يدهور في خلالها الدايه إلى جوفه بضعة أقداح من العرق- حينها تهبط الأسعار إلى حدودها الدنيا، وهو في “زهزهته”، فينده مصدري الضجة عند المدخل مستفسراً عمّا في جيوبهم. ثم يأتي دور أصحاب الطبائع الخجولة الواقفين، على الجهة المقابلة، من الطريق، بعيداً عن الصراخ والتدافش.
اما الدخول المجانيّ لمن كانت جيوبهم ممسوحة كقرعة أم موسى، فكان وقفاً على وجود والدة فؤاد الداية، اي خزّون العشي، وراء شبّاك التذاكر. فوالدة الداية كانت، على ما معلوم، تعاني من حَوَل شديد في عينَيْها. وما يزيد من طين الحول بلّة أنّها كانت كحوليّة، هي الأخرى، تشرب فتأخذ، إذا مشت، الطريق بالعرض، كما يقول العامة. وقد لاحظ الأولاد، مع توالي قطعها للتذاكر، في ما ينصرف إبنها إلى دقّ طاولة زهر مع أحد الأصحاب، أنّها كانت اذا تطلعت باتٌجاههم فهذا يعني أنّ عليهم الأمان، وأنّ بامكانهم التسلّل إلى القاعة لأنها لا تراهم، أمّا إذا كانت متطلّعة إلى الاتّجاه المعاكس، فمعناه أنّهم في دائرة بصرها، ولا ينبغي أن يحرّكوا ساكناً، وان المراوحة في أمكنتهم تحينّاً لفرصة، أمام المدخل، قد يكون أسلم من التعرّض للبهدلة.
ولمّا كان صاحب “سينما مرسال” ينتظر إمتلاء الفاعة بأكبر عدد ممكن من الروّاد قبل المباشرة بالعروض، فقد كان رواّد ذلك الزمان يضيقون ذرعاً بالإنتظار الطويل. لذلك درجوا على كسر ثقل الوقت الفاصل بالهتاف، بأعلى اصواتهم “يادوّر، يازمّر”. اي إمّا إبداً في العرض، أو أسمعنا اسطوانة. فإمّا أن يستجيب بالصورة، أو أن يصدح صوت عبد الوهاب، أو ليلى مراد، أو أسمهان، أو فيروز.
“أوّل نظرة”
ما بين إنشاء الصالة الاولى، صيف 1937، وبقيّة السنحة التي كرّت، توالياً، وفقاً لما سيأتيكم عنه، يمكن، في الأربعينّات التوقّف عند دخول سركيس باسيم إلى السينما المصريّة، من بابها العريض، من خلال تمثيله مع صباح في فيلم “أوّل نظرة”، من إخراج نيازي مصطفى، في 1946-1947. وباسيم هو من مواليد زغرتا، أواخر القرن التاسع عشر، توفي فيها، في 1971. تعلّم عزف الناي على مخائيل زاده، “أبو ريمون”، في مقهاه الكائن على ضفّة من ضفّتي المرداشيّة، فذاع له في عَزْفه صيت حتى عُرف، لبنانيّاً، ب”أمير الناي”، وقد رئس، لفترة، فرقة موسيقى زغرتا.
لذا كان من الطبيعيّ، حين بدأ شحرور الوادي يتردّد، مع جوقته، إلى زغرتا، وإهدن، ومجالس الأنس للإنعقاد حوله، حيث حلً، وصوت الدفوف للتعالي، أنيكون لباسيم في كل عرس قرص وينفخ، ما بين ردّة زجليّة واخرى، السحر. فتوطّدت صلته بالشحرور، وكان له من إشعاره التي خصّ بها اهدن أهلاً، نبعاً، وطبيعةً غنّاء، وزغرتا عنفواناً، كرماً، مرداشيّة، وسلمى نعّوم صوتاً زغرتاوّياً رخيماً، كان له نصيبه، هو أيضاً. والشحرور قدّمه، في أحد المجالس، إلى والدة صباح فطلبت منه ان يُصاحب، بالعزف، إبنتها المطربة الصاعدة صباح. فقبل ورافقها، في حفلات عّدة، في فلسطين وسوريّا، ثم مثّل معها “أوّل نظرة” وكان دوره القرويّ صاحب الناي.
وقد أخذت بعض لقطات الفيلم في إهدن عند نبع مار سركيس، وبيت إدوار البطش (بيت السيد ميلاد الغزال معوّض، حاليّاً)، وبستان محسن شلهوب، على طريق سيّدة الحصن.
بقية الصالات
سينما البايو
بعد أحداث 1958، وتحديداً في 1959، أنشئت صالة سينمائيّة ثانية، في زغرتا، عُرفت ب”سينما البايو”، في ملك الشيخ حميد كرم (مبنى البلديّة قبل الأحداث المذكورة)، قبالة كنيسة مار يوحنا المعمدان. وقد كلّف تجهيزها بنحو 100 كرسي، وبدل إستئجارها 3 آلاف ليرة لبنانيّة. وما هو معروف، عن هذه السينما، الآن، هو أنّها حملت، في بداياتها، إسم “سينما فلوريدا”. ثم حلّ إسم “البايو” محل الإسم المغمور كليّاً الآن، لسببين: أغنية سيلفانا مانغانو الحاملة هذا العنوان والتي شاعت بعد فيلمها “آنا”، والطريقة التي درج الشقيقان الابكمان حارس ويوسف زكا يعقوب “من كرم المهر-الضنية) على مناداة مؤسّس الصالة بها: جرجس يوسف الخوري واكيم يميّن (1902-1977) فكانا “يندهانه” “البايو” (اي بابا) كونه حدب عليهما، وتولّى تنشئتهما مدّة.
وقد دشّنت “سينما البايو” عروضها بفيلم “بائعة الخبز” لأمنية رزق. أمّا أوّل من شغل آلاتها فكان جوّاد الجعيتاني المار ذكره.
وقد كان ل”سينما البايو” فرعها الصيفيّ في إهدن، أيضائص، اولاً في ملك محسن بو ديبـ حيث محلّ ألفراد القارح، لاحقاً (كراسي غير ثابتة ومقاعد خشبيّة)، ثم في عنبر شاده أصحابها من الإنترنيت المسقوف صفيحاً، قرب بانسيون زخيا (250 كرسيّاً) تضرّر، غير مرّة، من جرّاء تراكم الثلوج قبل غيابه وبقائه أخضر الدفوف والحضور لدى الذاكرين من عمرٍ طريّ.
الصالة الشتائيّة في زغرتا، خضعت لأكثر من تعديل، وقد إنتهت إلى 350 كرسيّاً.
صالات اخرى
الستينّات طبعها قيام صالتين إضافيتين أصغر حجماً، وأقصر عمراً:
“الريفولى” لصاحبيها سركيس جواد الجعيتاني (هاجر الى فنزويلا وتوفي فيها العام الماضي) وأنطوان الرعيدي، قبالة الدهليز، في محلّة الساحة، وسينما “الروكسي”، لصاحبها دافيد ابشي (1923-1966) قرب قصر الرئيس الراحل رينه معوّض. وقد كان لها فرعه الصيفيّ، لفترة، في أوتيل أبشي-إهدن.
:السبعينات شهدت ولادة أكثر من صالة
سينما كونكورد” لصاحبها رشيد جعيتاني في 1977 (182 مقعداً)
“سينما الإليزيه” لصاحبها حمد كعدو في 1978 (400 مقعد)”
سينما الحمرا”لصاحبها يوسف قبلان معوض في بنايته في شارع المغتربين 1977″
سينما الإتوال” لصاحبيها فريد وجورج حليم طيّون في 1978″
صالتان اليوم
دارتان تفتحان، الى الآن، ابوابها، شتاءً، أمام الروّاد الذين إنخفض عددهم كثيراً بالمقارنة مع ايّام العزّ
“سينما مرسال” (135 كرسيّاً) الصالة الأولى المعاندة بقاءً، والبادية للعديدين مستودع ذكريات، ومبعث حنين إلى العمر الهاشل على حصان الأيّام، “وسينما كونكورد” فيما باقي الآرمات إمّا إلى إنطفاء، أو إلى تعثّر ك “الاليزيه”، أو لمنح مساحتها، آناً فآخر، للمسرح ك”سينما إتوال” ويبرز إسم رشيد جعيتاني كأحد آخر فرسان إستثمار الشاشة الكبيرة متقاسماً عائد تشغيل السينما القديمة (أي مرسال) مع آل الداية (الملك لبطرس المكاري المتقدّم عنه)، وملكيّة الفرع الصيفيّ مناصفةً مع بطرس جرجس يميّن، إلى إمتلاكه ل”الكونكورد”
والبقيّة… سيكتبها المصير الذي سيؤول إليه وضع السينما بنتيجة مكابشتها اليومية، والمتتابعة فصولاً، مع التلفزيون، ونصيره الفيديو
ملاحظات اخيرة
خارج إطار الإستثمار، داخل الصالات المعروفة، يمكن أن نتوقّف، تبعاً للتدرّج الزمنيّ، عند حفلا خيال الظلّ التي كان الفنّان يوسف القوّال يقوم بها، في بيته الوالدي، أوّل عهده بالرسم. ثم، عند الآلة السينمائيّة التي صنعها بدوي صوما وإجتذبت إلى منزله متابعين. كما عند الحفلات الدوريّة التي نظّمها، أواسط الخمسينّات، “النادي الرياضي” متعاوناً مع المكتبة الأميركية في طرابلس في مركزه الذي أزاله إنشاء “ثانويّة زغرتا الرسميّة” قبالة محلاّت المختار الراحل رشيد الفاحص. فضلاً عن العروض، في الطلق، في ليالي ميدان إهدن، وكانت إمّا من تنظيم وزارة الزراعة، ولها طابع إرشاديّ للمزارعين، أو تتّصل بسيرة وجه مهجريّ زغرتاويّ “كملك القنّب” المرحوم قبلان مكاري
أمّا ما يستحقّ توقّفاً أطول فهو فيلم “مناظر من لبنان” للسيّد ألبير يميّن الذي إستغرق إلتقاطه، عام 1959، أشهراً عدّة، بعدسة 16 ملم وطافت، في غضون تصويره، عدسة يميّن على الأماكن الأثريّة اللبنانية، والمدن الرئيسيّة،والبلدات والقرى الإصطيافيّة، في الفصول الأربعة
فكان له شريط بمدّة ساعتين رافقه بالصوت الصديقان انطوان القوّال ونجيب إسكندر. وقد طار يميّن لإجله إلى ديار الإنتشار بقصد الطواف به على المغتربين اللبنانييّن، وبخاصة الزغرتاوييّن. إلاّ أنً خاتمة هذا الفيلم الذي رافقه، حين عرضه في الخارج، السيّد ميلاد الجعيتاني، لم تكن سعيدة إذ تسبّب تركهما لجاكيتين جلديّتين في سيّارتهما المتوقفّة، في أحد شوالرع نيويورك، إلى كسرها وخلعها، وسرقة جميع محتوياتها، بما فيها الفيلم الذي سرق من صانعه، والمساهمين فيه، وقتاً ثميناً
ونختم هذا العرض بإشارات على شكل نقاط سريعة غير مدّعين لنفسنا إحاطة كاملة بجوانب الموضوع الفالش حاله على ما يقارب القرن. ولعلّ ما جمعنا يكون حافزاً لراغبين في التبسّط.
إنتاجاً: مستقراً في مصر لمع الزغرتاوي طنّوس فرنجية، في حقل الإنتاج.
تمثيلاً: لم يتبع باسيم إلى مصر تمثيلاً سوى مادلين طبر التي لا تنفكّ تحت الاضواء.
تصويراً: بعد فيلم “أوّل نظرة”، أخذ المخرج اللبنانيّ جورج نصر لقطات عدّة من فيلمه “الغريب الصغير” (1960) في “تكميليّة زغرتا الثانية للبنات” ويظهر، في عداد الكومبارس، في الفيلم، طنوس دحدح، من زغرتا، كما كان ذلك شأن الديب ميشال نمنوم الذي ظهر، هو الآخر، في فيلم “سلام بعد الموت” لجورج شمشوم الملتقطة بعض مشاهده في مزيارة.
وعلمنا ان المخرج محد سلمان أخذ لقطات من أحد افلامه في إهدن لكننا لم نعلم ايّها تحديداً. (ويشار إلى المشاركة الزغرتاويّة في فيلم “اماني تحت قوس قزح” (1985) عبر مساهمة جورج يمين في السيناريو والحوار
إخراجاً: ما خلا الأستاذ سايد كعدو لم نعرف، في زغرتا، من إتّجه للتخصّص في حقل الإخراج السينمائي
ونذكر في عداد الهواة الذين صوّروا زغرتا قبيل، وبعد حرب السنتين: الصديق جوزيف الحاج، والسيّد غسان طيّون كما لا تغيب عنّا مساهمة الزميل السابق بول مرقص الدويهي في إصدار مجلة سينمائية باللغة الفرنسيّة، في السبعينّيات، متعاوناً والمخرج جورج شمشوم، صاحب المجلّة
وإذا نسينا لا ننسى تذكير “نادي السينما” الناشط حالياً، بان أوّل من تولّى، في الستّينيات، تنظيم حفلات “سينما كلوب”، في زغرتا، كان الأستاذ أنطوان عويس الذي غادر خلال الحرب، إلى باريس وإستقرّ فيها، بمعونة عفيف دحبورة العامل، حتى الآن، في مركز السينما التابع لوزارة الإغلام اللبنانية
سنة 1927، كتب أندريه برج أن فنّ الشاشة هو أوّل من عرف كيف يمزج الماضي بالحاضر بالمستقبل. وهذا، على ما نخال، كان حال ما سطّرناه أعلاه، على أمل إفادة
محسن أ.يمّين
“Zghartapedia”لِ

